فلسطين المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: بثت قناة "دويتشه ڤيلا" الألمانية فيلما وثائقيا بعنوان "بين غزة وسديروت.. نضال عوائل من أجل السلام"، حيث بدأ مشاهده من مستوطنة "سديروت" القريبة من قطاع غزة، وكان من الملاحظ أنه حاول أنسنة المستوطنة منذ البداية عبر اختيار مشاهد لأطفال يلعبون في إحدى الحدائق، ثم مشاهد من أحد الأسواق، والمثير للانتباه هو اختيار فئات عمرية حساسة، أطفال في الحديقة وكبار سن في السوق، بينما يختفي العنصر العسكري في مستوطنة تعد مركز تواجد مكثف لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المشاهد الحيوية المذكورة سابقا، التي اختارها الفيلم، تنتهي بإطلاق صواريخ من قطاع غزة، ثم تتوالى مشاهد اختباء الطلبة في المدرسة مع التركيز أيضا على فئة عمرية محددة، الأطفال، ولون بشرة محدد "الأبيض" وهي محاولة لاستمالة الرأي العام الغربي (الأبيض) على ما يبدو، في ضوء أن مستوطني سديروت معظمهم من الشرقيين، ويظهر لاحقا نص مكتوب فيه: "25 ألف صاروخ سقطت على سديروت خلال 15 عاما". هذه الإحصائية مهمتها تصوير حجم الخطر الواقع على التركيبة العمرية السابقة، وعلى مشاهد الحياة التي تم انتقائها. كما أن اختيار مشهد البداية لقصف من قطاع غزة يراد التدليل من خلاله أن المبادر في الهجوم هو المقاومة، وليس الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتدى على هذه الأرض باحتلالها وعلى غزة بحصارها وممارسة المجازر بحق أهلها.

يظهر الفيلم أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة يأتي في سياق الرد على "هجمات قاتلة"، أي أنه دفاع عن النفس، وقد استعان بهذا العنوان من خبر لـ"بي بي سي" وذلك لينقذ نفسه من تهمة ترتيب السياقات بشكل مشوه، حتى الصورة الجوية التي استخدمت في الفيلم قبل مشاهد القصف الإسرائيلي، هي صورة تستخدمها الجيوش بالعادة للتدليل على دقة ومحدودية طبيعة الأهداف التي تقصفها، وكأن الرسالة منها أنه في مقابل العشوائي الفلسطيني الذي يعرض كل مستوطني سديروت بمختلف فئاتهم العمرية للخطر، يسدد جيش الاحتلال أهدافه بدقة.
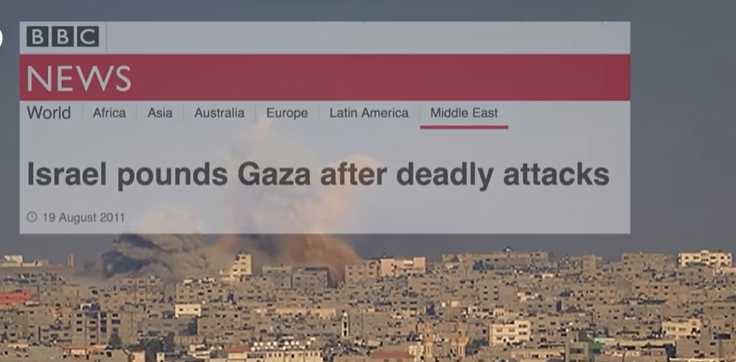
يظهر الفيلم في أحد المشاهد نصًا كتب فيه أن آلاف الفلسطينيين قتلوا في غزة خلال السنوات الأخيرة معظمهم من المدنيين، لكن اختيار مشهد الخلفية للنص كان من مسيرات العودة لمقنعين يشاركون في تظاهرات على السلك الفاصل، وهذا التزاوج بين النص والصورة هدفه التأكيد على أن المدنيين الذين يقتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الغالب يكونون جزءا من نشاط عنيف حتى وإن لم يكونوا من حملة السلاح، في المقابل يظهر الجيب العسكري الإسرائيلي وهو يستخدم أدوات تفريق المظاهرات غير المحرمة دوليا كقنابل الغاز المسيل للدموع، لقد طرح الفيلم بهذا المشهد والنص مفارقة مفضوحة، فالغاز المسيل للدموع لا يقتل، بل عمليات القنص والتدمير، والآلة (الجيب العسكري) ليست هي القاتلة، وإنما الجندي المستعمر الذي يجلس في قلبها.

ثم يشير الفيلم إلى مسيرة العودة بنوع من المغالطة التاريخية، يذكر أن خروج الفلسطينيين كان بهدف العودة إلى وطنهم السابق الواقع اليوم في "إسرائيل"، ثم لا يطرح تفسيرا لهذا التناقض، كيف يمكن لوطن لجماعة من الناس أن يتحول إلى وطن لجماعة أخرى؟ كيف حدث ذلك؟ ولماذا حدث ذلك؟ ومن يدعم ذلك؟. هي أسئلة لا يستطيع الفيلم المتورط في الرواية الإسرائيلية الرد عليها، لكنه اختار هذا السبب تحديدا ليخفي أسباب أخرى مهمة لهذا الخروج، هي الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، لقد اختار الفيلم سببا غير مقبول لدى القانون الدولي الذي أعاد تعريف أراضي 48 على أنها "إسرائيل".

وبالتزامن مع عرض الفيلم لمشاهد من مسيرة العودة، يظهر شاب اسمه أحمد يقف بعيدا عن حركة الجماهير يجري اتصالا مع إسرائيلية على الجانب الآخر من السلك الفاصل، ولعل الهدف من هذا المشهد هو أنسنة التواصل مع الإسرائيليين على حساب حركة الجمهور وتظاهرهم، التي يحاول الفيلم أن يظهرها على أنها حركة غوغائية بهدف مستحيل وغير شرعي، بينما البديل الأسلم والأكثر حضارية هو هذا الاتصال بين شاب غزي في مقتبل العمر، وعجوز إسرائيلية من سديروت قلبها عليه وعلى غزة. ثم يعود الفيلم ليقع في تناقض آخر من خلال حديث أحمد، الذي يورد أسبابا أخرى للتظاهر غير تلك التي تبناها الفيلم.
يظهر الفيلم مسيرة مؤلفة من مجموعة صغيرة من المستوطنين الذين يقولون إنهم تعبوا من الحرب، محاولا إسقاط هذه الصورة الحمامئية على مجتمع المستوطنة، التي يطالب رئيس بلديتها - المنتخب من مستوطنيها - طوال الوقت بتنفيذ عملية برية في قطاع غزة وتكثيف القصف الجوي، وهو الأكثر انتقادا لحكومات الاحتلال في سياساتها تجاه غزة، وهو الأكثر تمثيلا وشعبية في مجتمع المستوطنة لأنه منتخب من قبل مستوطنيها.

وخلال إجراء مقابلة مع إحدى المستوطنات، يظهر فجأة نصا لا علاقة له بالمقابلة ويتم تثبيته على الشاشة: "جسور لا أنفاق". إنها محاولة أخرى لإلقاء مسؤولية الحرب على عاتق الفلسطينيين، فكما بدأ الفيلم بمشاهد للصواريخ، الآن يطرح أداة أخرى من أدوات المقاومة الفلسطينية وكأنها نقيض لحالة الهدوء التي ينادي بها الفيلم أو يتبناها، بينما يغفل أدوات الحرب الإسرائيلية الأكثر تطورا وفتكا ودمارا.
هذا التحليل هو لأربع دقائق فقط من أصل 42 دقيقة، ويمكن اعتماده كمنهجية لتفكيك وقراءة باقي المشاهد، لكن الأخطر الذي حمله الفيلم هو محاولة تنميط التواصل مع الإسرائيليين عبر الهاتف بقوالب إنسانية، وهو أمر بالإضافة إلى أنه تطبيع مرفوض مع مجتمع احتلالي يشكل وجوده على الأرض الفلسطينية اعتداء وجريمة مستمرة، يحمل أيضا مخاطر أمنية على مجتمع غزة الذي يشكل حاضنة شعبية لأبرز ظاهرة مقاومة مسلحة في فلسطين، خاصة وأنه من المعروف أن معظم عمليات تجنيد العملاء من قبل مخابرات الاحتلال تتم عبر الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وتبدأ في الغالب بحديث "إنساني".











